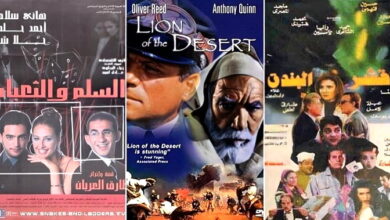المهرجاناتالمهرجانات العربيةسينما سوريةمهرجان أبو ظبيمهرجاناتنقد
العودة إلى حمص.. برميل بارود سينمائي في وجه أنظمة القمع

يرصد جحيم ومعاناة مدينة سورية
“العودة إلى حمص” .. برميل بارود سينمائي في وجه أنظمة القمع
أبوظبي ـ خاص “سينماتوغراف”
لم يتدخل المخرج السوري طلال ديركي كثيراً في فيلمه “العودة إلي حمص”، والمشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان أبوظبي السينمائي في دورته الثامنه، بل ترك المَشاهد تنساب بتلقائية، معتمداً على الحدث الطارئ وتوثيق اللحظة الآنيّة. فهو حين ينتقل مع بطله الرئيسي (عبد الباسط ساروت) من مكان إلى آخر، راصداً ما يشبه يومياته في القتال، لا يعرف ماذا ينتظره. كل شيء يتمّ في هذه اللحظة، لحظة التصوير، من دون توقُّع أو تحضير، أو حتى تدخّل. كأنه القدر فقط، هو صائغ الفيلم، كما يصوغ حياة السوريين.
ركزت غالبية أحداث “العودة إلي حمص” على الحياة العادية لبطل عادي، لفرد من أفراد المجتمع السوري الذين صاروا أبطالاً في الثورة، دون قصد، ودون رغبة بالبطولة، كل ما يريدونه، هو الدفاع عن كرامتهم وكرامة الوطن. و”عبد الباسط” هو واحد من آلاف الناس العاديين، لا خبرة له في السلاح، وليس لديه الكثير من العتاد، لكنه بإمكانياته الصغيرة يذهب إلى الجبهة.
وإلى جانب شخصية عبد الباسط، يرصد المخرج، حكاية متقطّعة للناشط الإعلامي (أسامة) أحد الذين برزوا في توثيق الأحداث، وهو أيضاً من أبناء حمص، من حيّ الخالدية، وقد أصيب بشظايا قذائف الهاون، ثم انقطعت أخباره في أثناء الفيلم بسبب اعتقاله من قِبَل النظام.
وكشف المخرج في تعليقاته الصوتية التي رافقت عرض فيلمه، إنه كان يَّمر بحمص في الماضي وإنه لم يُفكر في زيارة المدينة. حتى إنطلقت الثورة السورية، والتي وجدت في “حمص” قلعة حصينة، أجبرت المخرج على الإنتباه، ليتوجه إلى هناك، ويُصور أكثر من 200 ساعة، وعلى مدار عامين من عمر الثورة، يختزلها لاحقاً في ساعة ونصف، وقت فيلمه “العودة الى حمص”، والذي بدا كيوميات للمدينة، من إنطلاق ثورتها الشعبية، إلى تدميرها، ثم حصارها.
يسير الفيلم على الترتيب الزمني التصاعدي، فيبدأ من بداية الثورة في المدينة، وينتهي بالمجموعة التي رافقها لعامين، تحاول العودة للمدينة المحاصرة من قبل قوى الجيش السوري النظامي. التفاصيل التي نقلها الفيلم، ربما تكون الأولى من داخل المدينة طوال العامين الماضيين. الأحداث التي سمعنا عنها في نشرات الأخبار، من هجمات متواصلة، وتبادل الحكومة والمعارضة السيطرة على أحياء المدينة، سنرى إنعاكسات لها من الجهة الأخرى، من قلب المدينة ومن أحيائها. المخرج يفتح باب “جحيم” حمص، ويقدم مشاهد مفرطة بعنفها، لشباب سوريين، يصابون أمام أعيننا، وبعضهم يلفظ الأنفاس الأخيرة خلف عدسات الكاميرات، لجثث يجتمع عليها الذباب، مرمية على خطوط النار العديدة، التي تشق أحياء الحي الواحد، عائلة تتجمع حول جثة إبنها الذي لم يتجاوز العاشرة، مرمياً في صالة بيت فارغ من كل شيء.
ويصل الفيلم إلى حيث لم تصل كاميرات الإعلام أو الناشطين، ويرافق “عبد الباسط ساروت” في ثكناته المتنقلة بعضها غرف نوم سابقة وبنايات متهاوية. كما تذهب معه الكاميرات إلى الأنفاق السرية والقبور المتسعة وهو يحفر في التراب ليودع “رفيقاً” لم يخذله في المقاومة ويكتب بين الحجار المتناثرة اسمه للذكرى.
ومهما كان موقعك السياسي من الأزمة في سورية، لا يمكن تجاهل نقل الوثائقي معاناة الإنسان السوري أولاً ومن داخل حمص. هناك النازحون الذين يهربون إلى الشمال، وهناك الكنائس والمساجد المدمرة. هناك أيضاً أسامة قبل أن يختفي يفتش داخل حطام منزله عن كاميرا وفنجان كتب عليه “سورية”. ويكاد عبد الباسط في أحد المشاهد يفقد صوابه وهو يصرخ في الفيلم مشيراً إلى الجثث في الشوارع، حيث الموت ينتشر بشكل مرعب يفوق التخيُّل، وكأن عبد الباسط يستنجد بالكاميرا لتنقل للعالم عار الجثث المتروكة التي لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها، خوفاً من القنص أو القذائف المتساقطة.
الخراب هو المفردة التي تفاجئ العين وتربكها. لا يمكن لأي فيلم تخيلي أن يتفوَّق على لقطات الخراب الواقعية. تلك الغرفة الأنيقة، حيث الستائر البيضاء، الفرش الأنيق، وقد سقط أحد جدرانها بالكامل فأصبحت مفتوحة على المدينة. ثقوب في كل مكان، العمارات المُخَرَّبة وكأننا أمام مشهد أسطوري لحرب قديمة. البيوت التي هجرها سكانها، الممرّات التي حُفِرت بين البيوت، في الجدران التي يفضي أحدها إلى الآخر، لتكون بمثابة ممرّ مشاة آمن إلى حَدّ ما، حيث العبور من بيت إلى آخر، عبر الفجوات والجدران المحطّمة. وكلما شعر الساروت باقتراب الموت تحدَّث عن أمنية الشهادة. يتحدَّث عنها وهو في حالة الاسترخاء، وفي أثناء حديثه مع الأصدقاء، وقبل الذهاب إلى المعركة، ترافقه الأمنية في حالات اليأس والتعب.
وحين يموت رفاقه، ويحسّ بأن كل من يحبّهم ماتوا، يرغب الساروت بالشهادة. وكذلك في حالة القتال، ولَمّا أُصيب الساروت بشظية في ساقه، راح يوصي أصحابه بما يشبه الهيستيريا: “لا تنسوا دم الشهداء”. في هذه اللحظة، يتحوَّل إلى كتلة انفعال مندمجة مع أصوات الغائبين، تجعله يصرخ باسم جميع الشهداء. وبعد الصدمة، وعودة الاسترخاء، وانزياح الموت قليلاً، يتحدَّث عن النسيان، فيلتقطه مخرج الفيلم ليسأله عن النسيان، فيجيب أن النسيان نعمة، ولكننا لا ننسى الأبطال الذين استشهدوا. ولأن الصورة تمرّ سريعاً، والبعض يمكن أن ينساها، سيظل هذا الفيلم ويبقى بما رصده برميل بارود سينمائي في وجه كل أنظمة القمع.