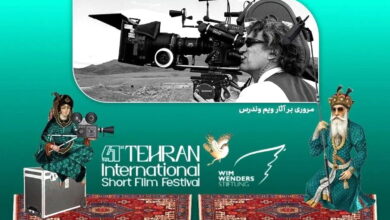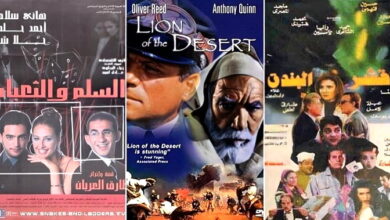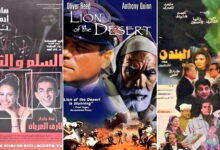المهرجاناتالمهرجانات العربيةسينما مصريةسينمانامراجعات فيلميةمهرجان القاهرةمهرجاناتنقد
باب الوداع.. بين التحلل والتحرر

أحمد شوقي يكتب لـ “سينماتوغراف”
“باب الوداع”.. بين التحلل والتحرر
في ثلاثة مشاهد تأسيسية، متأنية ومتتالية، يؤسس كريم حنفي عالم “باب الوداع” الدرامي كاملا لمن يريد أن يدخله. عالم تشكل الهواجس فيه أشخاصا من لحم ودم، لهم حيزهم الحياتي وتأثيرهم على الدراما، عالم كلمة السر فيه هي الحب الموصوم برهاب التحلل.
الأم (سلوى خطاب) تجلس أمام المرآة، بالأبيض والأسود، لون الحلم أو العقل الباطن كما سنكتشف من اللقطة التالية السريرية الملونة، وتقوم بقص شعرها ببطء. البطء هنا هو عامل الاختلاف بين قص الشعر كفعل تطهيري أزلي، وبين نفس الفعل كهاجس يقبض على روح الشخصية. الأم لا تتطهر من شعور بالذنب، لكنها تسابق القدر، بيدي لا بيد الزمان، هذا لسان حالها، خصلة بخصلة تجرب شعور التحلل، الغول الذي سيأكل أجسادنا عاجلا أم آجلا.
الجدة (آمال عبد الهادي) في المقابل تهزأ بهذا الغول، على صوت القرآن الذي سيُتلى يوم وفاتها تصفف شعرها، تلتقط ما يتساقط منه بعناية، تلفه في ورقة حلوى ملونة وتحتفظ به في علبة صغيرة، تم تحول الراديو لأغنية رومانسية تسمعها وهي تدخن سيجارتها بهدوء. جسد الجدة يتحلل تلقائيا بحكم الزمن، لكنها لا تعبأ بهذا التحلل، تتعايش معه وتتحداه بشعيرات ستبقى بعد أن يواري التراب صاحبتها.
أما الابن الطفل، الذي بدأ الفيلم برحلة تعميدية أخذته فيها الجدة لتخطي عشرات القبور، فيقف في نفس مكان والدته، أمام مرآتها، يجرب مساحيقها وعطورها ممتصا بعض روحها، ثم يفعل تماما مثلها: يأخذ دميته ويغلق عليها بابا غير محكم، لترقد الدمية المسكينة ممزقة بسكين الإضاءة داخل حبس مظلم تشرق داخله الشمس أحيانا.
“أنا ابن أمي.. ابن خوف أمي.. ابن حزن أمي”..
هكذا يردد الابن الشاب (أحمد مجدي) في واحدة من مرات ثلاث يتحدث فيها، ليضع نتيجة واضحة للصراع الذي سبق العبارة خلال الفيلم، صراع الابن بين الجدة المتصالحة مع الموت كوسيلة للتحرر والأم المذعورة منه كسبب للتحلل. ليبدأ انطلاقا من العبارة النصف الثاني للفيلم، التطهيري أو لنقل التحرري، الذي يصل في النهاية ليروي بالصورة ما قالته الكلمات في اللوحة الأولى من الفيلم “أنت يا من كنت دوما هنا..ستكون فى كل مكان”، في نهاية دائرية للسرد، تماثل ما في طرح الفيلم من أبدية وخلود: الموت هو البقاء.
دراما لمن يريدها
الحقيقة أني لا أفضل قراءة ما كُتب عن فيلم قبل الكتابة عنه، وإذا قرأته في فيلم خلافي كهذا لا أحب الإشارة إليه، ففي النهاية الهدف هو تناول العمل الفني بالتحليل، وليس دخول أي جدل أو سجال. لكن ما حدث من بعض من كتبوا عن “باب الوداع” يحتاج لطرح ونقاش، لأن منطلق الآراء السلبية عن الفيلم هو في الحقيقة منطلق سليم، لكنه لا ينطبق على الحالة، بما يحوله بصورة ما إلى حق يراد به باطل.
فإذا كانت ما تميز السينما عن المسرح والحكي الشعبي هي الصورة، فإن ما يميز السينما عن الفنون التشكيلية هي الدراما، وغياب الدراما كارثة حقيقية تحد من قيمة الفيلم بكل تأكيد (باستثناء التجارب الوسيطة كالتجريب والفيديو آرت، فلها معايير مختلفة)، لكن في النهاية نتفق على أن الفيلم الروائي الذي لا يحكي شيئا هو بالضرورة عمل ناقص مهما امتلك من جماليات. ويبقى السؤال: هل يمتلك “باب الوداع” الدراما الخاصة به؟ هل يحكي شيئا؟
إجابتي هي نعم بالطبع، الخط العام للحكاية اخترت أن أبدأ المقال به، وأرويه من رحم الفيلم نفسه ومن مشاهده وتتابعها، وأؤكد على ذكر التتابع كقيمة سردية اكتشفها ليف كوليشوف بتجربته الأشهر في التاريخ، التي أسست لفكرة المونتاج كأداة سرد: قيمة وتفسير المشهد بشكل منفرد تختلف كليا إذا ما سبقه ولحقه ما يؤطر ويفسر. بالطبع لا يقول مشهد طويل تقوم فيه سلوى خطاب بقص شعرها ببطء شيئا كبيرا في حد ذاته (وهو المشهد الذي أثار حنق البعض ودللوا به على فراغ الفيلم من الدراما)، لكن نفس المشهد عندما يسبقه مشهد افتتاحي لاختراق الصبي لعالم الموت ممسكا بيد جدته، ويلحقه مشهد للجدة نفسها تتعامل مع نفس الموتيفة الدرامية “خسارة المرأة لشعرها” بصورة مغايرة تماما، فهذا تحديدا هو السرد السينمائي، وهذه بالضبط هي الدراما الشعرية ـ وإن كان الوصف صار سيء السمعة ـ التي تقدم مفاتيحها لمن يريدها، وتتعالى عمّن يتعالى عليها.
قد يكون هذا الشكل من السرد غير معتاد أو سهل الهضم، قد يجعل العمل الفني يخسر نسبة ضخمة من الجمهور، قد لا يكون حتى مناسبا للذائقة الشخصية للناقد، كلها أمور أعتقد أن صانع الفيلم كان يدركها وهو يختار أن يروي حكايته بهذه الصورة، لكن فيما يتعلق بالدراما، فأؤمن بأنها موجودة بل ومشتعلة، وتمتلك بناءً سرديا واضحا لدى الشخصيات الثلاث، تمت الإشارة له في مقدمة هذا المقال، ونواصل محاولة تلمسه فيما يلي.
حلم وحلم، تقاطع يحكي
مشاهد الأبيض والأسود هي مشاهد حلم أو عقل باطن، هذا ما يؤسسه تتابع مشهدي قص الشعر والاستيقاظ في السرير كما أوضحنا، وهو خيار تأسيسي سيستمر على مدار الفيلم: ما هو ملون واقعي، وما هو مجرد من اللون فوق واقعي (حلم/ هاجس/ عقل باطن/ أو أي شيء آخر). شكل واضح ـ بل وبدائي ـ للتمييز لا أعلم كيف لم يمسك به البعض. خيار تأتي ذروة قيمته الدرامية عندما تتقاطع الهواجس، عندما نشاهد ما هو فوق واقعي داخل عقل الابن، خوفه أو حلمه أو ذاكرته، من وجهة نظره والأبيض والأسود، يفتح بابا فيطّلع على نفس مشهد الأم أمام المرآة.
حتى هذه اللحظة تكاد تكون الشخصيات معزولة حتى لو ظهرت مع بعضها، كانت الدراما تعتمد على خلق جو عام موحٍ، وتوازي هواجس الشخصيات بالمقارنة والمقاربة. لكن عند هذه اللحظة التي تأتي عند ربع زمن الفيلم تقريبا، يبدأ التصعيد الدرامي النفسي ومفاده: هذا الطفل تشبع بأمه، بخوفها من الغياب والتحلل، ببقائها دوما وراء باب مغلق، بكراهيتها لما يذكرها بالماضي، على النقيض من أمها التي تعتز في كل ظهور لها بانتمائها لهذا الماضي: خصلات شعر محنطة/ بدلة فرح قديمة/ ألبومات صور بالية، هذه امرأة متسقة مع سرمدية الوجود، تنتظر فقط دورها في الانضمام. أما التقاطع فيقول أن الابن لا يزال أمامه الكثير ليكون مثلها.
تكوين وتصوير
حسنا، لقد أرجأت الحديث عن عنصر التصوير للنهاية، لأنه تحول لأداة هجوم ودفاع معا، من يرفضون الفيلم يشيدون بالتصوير كنوع من ذر الرماد، ومن يحبونه يشيدون به كإنجاز يمنح الفيلم شرعية. الحقيقة أنه لا هذا ولا ذاك، ومجددا أتفق مع الرأي الهجومي في المبدأ العام: التصوير وحده ليس إنجازا، والصورة الجميلة قد تكون فوتوغرافية أو إعلانية بقدر كونها سينمائية. والحقيقة أن قوة صورة زكي عارف ليست في تميزها بشكل مجرد في التكوين والإضاءة والمناظير، ولكن في كونها قيمة مضافة حقيقية، تنطلق من الدراما وتتحرك بها.
الضوء الذي يشق رأس الدمية ليس إضاءة جمالية إعلانية، لكنه تعبير درامي عما تمثله الدمية لمالكها، وما يمثله هذا المالك تباعا لمالكته (الأم)، ووقوف الابن وراء الزجاج يشاهد توالي الفصول ليس كارت بوستال جمالي، لكنه مرتبط بثاني مشاهد الفيلم الذي نرى فيه الابن طفلا يركض من وراء نفس الشباك ممسكا بطائرته الورقية التي تطير داخل المنزل وليس خارجه. وهو نفس الشباك الذي تحطمه عواصف التحرر في مستوى فوق الواقع قبل أن يتحرر الابن ويخرج وحيدا للمرة الأولى على شريط الفيلم. هذه روابط بصرية درامية تعطي معنى للصورة أبعد من جمالها الشكلاني، لكنها تحتاج لجهد أكبر من المعتاد في تلقيها، مجددا ممن يريد التلقي.
وفي البداية
لن أختم بملاحظة نهائية اعتيادية لأن كل ما حدث هو بداية، بداية لصناعة أفلام تروى بطريقة مختلفة عن التراث والمتوقع، بداية لحضور أكثر من ألف شخص لعرض فيلم غير مفهوم للغالبية لكنهم يحترمونه للنهاية حتى وإن لم يرضوا عنه، وبداية لحلم امتلاك هامش تواجد ولو ضئيل لسينما مغايرة للسائد التجاري والسائد الدعمي (نسبة لصناديق الدعم)، والذي صار هو الآخر تيارا سائدا بين البعض، لكن لهذا حديث آخر.