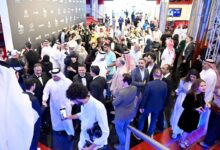محمود ياسين الظاهرة الفريدة في حياتنا الفنية

ناصر عراق يكتب لـ «سينماتوغراف»:
مهرجان الإسكندرية السينمائي يطلق اسمه على دورته الجديدة
النجم الوحيد الذي وقف أمام أشهر وأهم النجمات اللاتي سبقنه!
في لفتة ذكيه انتبه القائمون على مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة إلى الدور المهم الذي لعبه النجم القدير محمود ياسين في تاريخنا السينمائي، فأطلقوا اسمه على الدورة 31 التي تعقد حاليا في عروس البحر الأبيض المتوسط، وبغض النظر عن فوضى الافتتاح وسوء التنظيم إلا أن تكريم هذا الرجل وهو مازال على قيد الحياة – رعى الله أيامه ولياليه – أمر واجب نظرًا لتاريخه الثري مع الفن السابع الذي يستحق أن نتوقف عنده طويلا بالدراسة والتمحيص، وهو ما نسعى لفعله في السطور التالية.
في 19 فبراير 1941 ولد النجم محمود ياسين، كما تؤكد معظم المصادر، وطوال فترة السبعينيات من القرن الماضي تربع على عرش السينما المصرية بامتياز، فكان هو البطل الأول في غالبية الأفلام التي ينجزها المخرجون آنذاك، حتى صار اسمه وملامحه وطريقة أدائه وتسريحة شعره، وحتى موديلات (قمصانه وبدله) عناوين لعصر وإشارات لزمن، فهل موهبته المتميزة هي التي جعلته يصعد عاليًا هكذا في سماء الفن؟ أم أن للظروف دورًا آخر لا يقل أهمية عن مهاراته في التمثيل؟
الهزيمة والنجم الصاعد
في ظني أننا لا يمكن أن نفهم أية ظاهرة فنية بدون الالتفات إلى الأجواء المحيطة التي انبثقت منها هذه الظاهرة، كما لا نستطيع تفسير الحضور الطاغي لمحمود ياسين في سبعينيات القرن المنصرم بدون تقديم قراءة دقيقة لهذه الفترة من حياتنا في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع، فضلا عن الفن بطبيعة الحال.
لعلك تعلم أن محمود ياسين اقتحم عالم السينما قادمًا من دنيا المسرح، حيث انضم إلى المسرح القومي مع منتصف الستينيات، وشارك بالتمثيل في عدة عروض متنوعة من أهمها (ليلة مصرع جيفارا العظيم) للكاتب ميخائيل رومان والمخرج كرم مطاوع، وقد حقق حضورًا لا بأس به على الخشبة، لكن تشاء المقادير أن يصعد نجم الممثل الجديد مع هبوط نظام سياسي عتيد، فقد استقبلت السينما وجه محمود ياسين عقب هزيمة 1967، إذ قدم مجموعة من الأدوار الصغيرة بدأها بفيلم (ثلاث قصص – قصة دنيا الله لنجيب محفوظ – للمخرج إبراهيم الصحن، وقد عُرض في 12 فبراير 1968)، حيث قدم دورًا صغيرًا جدًا، لكن الغريب أن اسمه كتب في مقدمة الفيلم هكذا (محمد فؤاد ياسين) وليس (محمود)، وليس عندي تفسير لذلك، فحسب علمي أن اسمه محمود فؤاد ياسين!
على أية حال شارك محمود بعد ذلك في أدوار صغيرة في أفلام (القضية 68) لصلاح أبو سيف، و(الرجل الذي فقد ظله) لكمال الشيخ، وفي عام 1969 لاح في أكثر من مشهد في فيلم (شيء من الخوف) لحسين كمال الذي منحه الدور الثاني في فيلم (نحن لا نزرع الشوك/ 23 مارس 1970)، فحقق حضورًا مميزا، فلما اختارته فاتن حمامة ليلعب أمامها البطولة في (الخيط الرفيع/ عرض في 13 سبتمبر 1971) انفتح باب المجد على مصراعيه أمام الفنان الواعد. لماذا؟
من المعروف أن المزاج العام للشعوب يتغير بشكل لافت عقب الأحداث السياسية والاجتماعية الكبرى، فلما انقصم ظهر مصر مع هزيمة 1967 ارتفع حائط صد نفسي كبير بين الجماهير وكل من كان له حضور اجتماعي قوي قبل الهزيمة، حتى عبد الناصر نفسه لم يسلم من الغمز واللمز، لذا لم يكن غريبًا أن يطال الشحوب نجوم السينما الذين كانوا يملأون الشاشة قبل الهزيمة، وإذا اتفقت معي على أن السينما فن ينهض على الشباب بشكل رئيسي، من حيث الموضوعات المطروحة على الشاشة، ومن حيث أن غالبية رواد السينما من الشباب، فإن نجوم ما قبل الهزيمة كانوا قد تجاوزوا الأربعين وما زالوا يمثلون أدوار الشباب، وهم أمر لم يعد سائغا لدى الناس!
تعال نتذكر هؤلاء النجوم في عام 1967 ونستعرض أعمارهم في تلك السنة (أحمد رمزي 37 سنة/ رشدي أباظة41 سنة/ شكري سرحان 42 سنة/ فريد شوقي 47 سنة/ أحمد مظهر 50 سنة/ فؤاد المهندس 43 سنة/ صلاح ذو الفقار 41 سنة/ عبد الحليم حافظ 38 سنة/ يحيى شاهين 50 سنة/ محسن سرحان 53 سنة)، أما حسن يوسف ومحمد عوض فأعمارهما حول الثالثة والثلاثين، أي أن أولئك النجوم قد تجاوزوا مرحلة الشباب وصاروا من الرجال الكبار الذين ترك الزمن آثاره على ملامحهم، فبات من الصعب تصديق أن عبد الحليم طالب في الجامعة في فيلم (أبي فوق الشجرة 1969) وعمره أربعين سنة.. هذا على سبيل المثال!
محمود.. المصري الجاد
أظنك تدرك أن المصريين لم يكابدوا شعورًا بالمرارة كما كابدوه بعد هزيمة 1967، فاعترى الناس، خاصة الشباب، قدر كبير من الاكتئاب والحزن، بعد أن كانوا مترعين بأحلام عظيمة وأمنيات كبيرة مع الصعود الناصري، فلما طلّ وجه محمود ياسين على الشاشة، شعر المشاهد أن هذا الشاب يشبهه، فقسماته تكتسي بحزن عميق، الحاجبان كثيفان مقرونان، والعينان عميقتان تبرقان بجدية دون تجهم، والوجنتان بارزتان قليلا لتمنح الوجه مسحة من إجهاد وكفاح، والبشرة خمرية مثل غالبية المصريين، أما جبينه فمنبسط كدليل للعزة والكبرياء، وكذلك يسهم طوله ونحافته النسبية في تأكيد مشاعر الجدية، ويبقى صوته الرخيم وأدائه الناصع ليضفيا على شخصيته الأصالة والاحترام (تأمل ملامحه في أفلام نحن لا نزرع الشوك/ أختي/ الخيط الرفيع/أغنية على الممر/ الزائرة/ ليل وقضبان) وكلها أفلام أنجزت في الفترة من 1970 حتى 1973،.
بعد حرب أكتوبر 1973 لعب محمود ياسين بطولة معظم الأفلام التي تناول صناعها هذه الحرب، ففي الذكرى الأولى للحرب أي في 6 أكتوبر 1974 عرضت له السينما في يوم واحد فيلمين هما (الوفاء العظيم) للمخرج حلمي رفلة، و(الرصاصة لا تزال في جيبي) لحسام الدين مصطفى، وبعدها بأسبوع واحد فقط رأيناه جنديًا شارك في الحرب في فيلم (بدور) للمخرج نادر جلال، ولك أن تعلم أن الأفلام الأخرى التي عرضت في تلك الفترة أي من أغسطس حتى ديسمبر 1974 كانت غالبيتها تتسم بسذاجة الطرح.. مصنوعة على عجل، لا تقدم فكرة جادة أو تطرح رؤية جيدة، بعكس الأعمال التي قدمها محمود ياسين عن الحرب برغم أية مآخذ يمكن لنا أن نلتفت إليها الآن. تعال نستعرض معًا أسماء هذه الأفلام الساذجة التي قدمت في تلك الفترة لتدرك لماذا التف الجمهور حول محمود ياسين صاحب الأعمال الجيدة التي تحترم عقل المشاهد وذائقته الفنية. خذ عندك (عريس الهنا/ في الصيف لازم نحب/ امبراطورية المعلم/ بمبة كشر/ شياطين إلى الأبد/ 24 ساعة حب/ عجايب يازمن)!
المأزوم نفسيًا
كما هي العادة.. تنتاب الشعوب حالات من الاكتئاب والإحباط بعد الثورات والحروب خاصة إذا كانت النتئاج القريبة لهذه الثورات والحروب مخيبة للآمال، وقد مرّ بمصر شيء يشبه هذا إلى حد كبير، فبعد انتصارنا في حرب 1973، انقلب النظام السياسي رأسًا على عقب، وصافح السادات أعداء الأمس، وتملص من أصدقاء أول أمس ولعنهم، وتم اغتيال عبد الناصر – الرمز – معنويًا بالكلمة والصورة، وتصدرت صور قادة إسرائيل الصحف المصرية بوصفهم أصدقاء، (تذكر قول السادات: صديقي بيجين)، وانفتح الباب واسعًا أمام انفتاح (السداح مداح) بوصف الرائع أحمد بهاء الدين، فتمزقت أفئدة الشباب، وتقلبوا على أسرّة الحيرة والتردد، فكانت النتيجة إنتاج (شاب) مأزوم نفسيًا.. حائر فكريًا.. مشوش ذهنيًا.. فقد البوصلة المرشدة إلى التقييم الصحيح، ولم يكن يوجد ممثل قادر على تجسيد هذه الاضطرابات النفسية والعقلية التي يكابدها الشباب أفضل من محمود ياسين، وهكذا انهمرت أفلامه التي تتكئ على الاهتمام بطرح الشخصية المضطربة على الشاشة مثل (الحب الذي كان/ 31 ديسمبر 1973) للمخرج علي بدر خان، (أين عقلي/ 21 يناير 1974) لعاطف سالم، (قاع المدينة/ 28 يناير 1974) لحسام الدين مصطفى، (الكداب/ 5 أكتوبر 1975) لصلاح أبو سيف، (العش الهادئ/ 18 أكتوبر 1976) لعاطف سالم، (سونيا والمجنون/ 10 يناير 1977) لحسام الدين مصطفى، (امرأة من زجاج/ 21 مارس 1977)، و(العذاب امرأة/ 21 نوفمبر 1977) لأحمد يحيى.
في كل هذه الأفلام وغيرها يلوح لنا محمود ياسين متوترًا.. عصبيًا.. حائرًا، ينشد الحق واليقين بلا جدوى، ولعلك تذكر المشهد البديع الذي قدمه في فيلم (سونيا والمجنون) حين قتل المرابية العجوز، وكيف اعتراه الذعر عندما رآها تخرج حية بعد أن هوى على رأسها بالسكين! إن هذه البراعة في تقمص حالة الشاب الموتور عصبيًا وذهنيًا جعلته يحقق نجاحًا مدهشًا حين قدم للتلفزيون مسلسلات متميزة تنهض على فكرة المأزوم نفسيًا مثل (الدوامة) و(الأبله) ومسلسل (القرين)، وكلها أعمال عرضت في السبعينيات، وكان المشاهدون ينتظرونها على أحر من (الفن)!
مع النجمات
بلغ محمود ياسين من المجد السينمائي ما لم يبلغه أي فنان من جيله، فقد كان هو الممثل الوحيد الذي تمتع بالقيام بالدور الأول أمام كل نجمات السينما اللاتي سبقنه في الظهور على الشاشة الفضية، فقد شارك الراحلة الجليلة السيدة فاتن حمامة في ثلاثة أفلام هي (الخيط الرفيع/ حبيبتي/ أفواه وأرانب)، ومع نادية لطفي قدم (قاع المدينة/ الأب الشرعي)، ومع ماجدة (أنف وثلاث عيون)، وشادية (نحن لا نزرع الشوك/ الشك يا حبيبي)، أما سميرة أحمد فقدم معها (ليل وقضبان/ امرأة مطلقة) ومع برلنتي عبد الحميد قدم (العش الهادئ)، وسعاد حسني (الحب الذي كان/ أين عقلي/ على من نطلق الرصاص)، وكان بطل آخر فيلم للمطربة الجميلة نجاة (جفت الدموع)، وبطل الفيلم الوحيد للمطربة الرائعة عفاف راضي (مولد يا دنيا)، علاوة على نجمات جيله نجلاء فتحي ونيللي وناهد شريف وسهير رمزي، والجيل الذي تلاه من أمثال يسرا وليلى علوي وآثار الحكيم.
أكثر من 160 فيلمًا هي رصيد محمود ياسين في بنك السينما، فلما انقضى عقد السبعينيات، وتغير الذوق العام للجماهير، وودع نجمنا عمر الشباب، بدأت السينما تعامله بحساب، وراح نجوم جدد يزاحمونه على شباك التذاكر حتى ابتعد تقريبًا عن الشاشة مع مطلع النصف الثاني من الثمانينيات، ثم توقف تمامًا عن العمل بالسينما لمدة عشر سنوات تقريبًا، وعاد في السنوات الأخيرة مع فيلم (الجزيرة) ليلعب دور الأب العجوز!
ذكريات خاصة
أرجو ألا يغيب عن فطنتك أن محمود ياسين ما كان له أن يحقق كل هذا النجاح لو لم يكن الرجل مزوّدًا بثقافة عريضة ومدعومًا بأخلاق حميدة، فطوال مشواره السينمائي لم يتعرض لأية شائعة مشينة أو خبر سيء كما يحدث لكثير من الفنانين، الأمر الذي جعل الناس تكن له تقديرًا خاصًا.
بالنسبة لي فقد فتنت بتمثيله وأنا صبي، فكنت أحرص على مشاهدة أفلامه في السينما، كما أنني ظللت أرسمه مئات المرات – بلا مبالغة – مستخدما جميع الخامات، سواء القلم الرصاص أو الجاف، أو الألوان المائية والخشبية، وقد أتيح لي إجراء حوار طويل معه دام نحو ثلاث ساعات قبل 17 سنة تقريبا، حيث تحدثت معه في فيللته بالهرم عن علاقته بالقراءة والثقافة بشكل عام (نشر الحوار في جريدة البيان الإماراتية آنذاك)، وأشهد أن الرجل واسع الاطلاع.. يمتلك ذهنا صافيًا مرتبًا، وقد بلغ به الأمر في عشقه للقراءة أن قال لي (أنا مجنون كتب، واسأل عني الحاج مدبولي صاحب المكتبة الشهير).
بمناسبة تكريم مهرجان الإسكندرية السينمائي له… لا نملك سوى أن نهمس في أذنه:
أستاذ محمود.. دمت مشمولا بالصحة والسعادة ووفرة الإبداع.