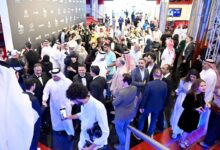Blow Up.. الوهم ببصمة الايطالي مايكل انجلو انتونيوني

«سينماتوغراف» ـ فراس محمد
(إذا كان لدي هدف فهو الهروب من الحرفية أو الموضوعية )، وردت هذه الجملة في محضر حديث المخرج البولندي الراحل كريشتوف كيشلوفيسكي عن سينماه، ولكن حديثه هذا، بدا فيه من سينما المخرج الايطالي مايكل انجلو انتونيوني الكثير، وخصوصا عند الحديث عن فيلمه Blow Up الذي منحه السعفة عام 66، العام الذي كان بمثابة تكليل نجاح للايطالي المبدع والذي أفضى عن ما سمي حينها بفيلم النقاد أو افضل فيلم لعام 66.. ما جعل هذه الجملة، افتتاحية مراجعة عن فيلم انتونيوني والتي اعطت في ختام هذا العمل السينمائي، قوة الواقع، وقوة موضوعيته، رغم ان نقطة انطلاقته كانت الوهم، ونقطة تأثيره الوهم، وطريقة طرحه واسلوبه اعتمد على الايحاء.
الرجل اراد ان يصنع فيلمه Blow Up بقوانينه الخاصة، دون أن يكسر أو يهمش ما ساد حينها، أو ما يُعتبر اليوم كلاسيكيا، وهي الحالة التي يتلقى بها الجمهور الفيلم، بالطريقة التي يتقبل فيها الجمهور هذه القوانين، كان انتونيوني يخبز في صوامعه مشروعا آخر، يروي حكاية اخرى، فأعطى للفيلم لون الواقع، وكساه بلغة الوهم، مع كثير من المشاهد التي تبدو خارج نطاق الفيلم أو غير متفرعة عنه، هناك مثلا مجموعة من الحمقى أو المجانين، يهرعون جيئة وذهابا في شوارع لندن، يتقبلهم الناس دون استغراب وكأنهم جزء من هذه المدينة، وجزء من ما تحمله من التناقضات التي سيبرزها انتونيوني في ما يتبع من مشاهد ولقطات، هناك سيارة فارهة، وبها جهاز راديو أو باعث اشارة، يتصل بها توماس شاب وسيم – اصبح فيما بعد ثيمة وجزء من الثقافة الشعبية شبيه بالحالة التي صنعها الفيس بريسلي في اميريكا او جون لينين في انجلترا – قدم الدور الانجليزي ديفيد هيمينغز، هناك ايضا مروحة خشبية عملاقة اثرية اشتراها هذا الشاب كديكور في قاعة التصوير، هناك ألبوم للصور يبرز كل فترة، يظهر به لقطات لم تعهدها مدينة لندن، في ازقتها، أو شوارعها الخلفية، وكأنهم عمال مناجم، أو اسرى حرب، لماذا هم في البوم صور هذا الرجل، ولماذا ابدى هذا الاهتمام بهم.
هذا ما يرينا اياه انتونيوني، ولكن في مكان آخر، يروي حكاية اخرى، حكاية الرجل الذي اكتشف جريمة قتل، في احدى المنتزهات، جريمة غامضة التفاصيل، تفاصيلها كما تبدو غير مكتملة، كادت ان تمنح الفيلم عنوان – فيلم اثارة أو جريمة -، ولكن في كل زاوية من زوايا هذه الحكاية، هناك حكاية اخرى، انتونيوني يحرض مشاهديه، يدفعهم لتحقيق هذه الروايات، لدمجها، للبحث عنها كما بحث هذا المصور – توماس – عن الجريمة المخفية في زوايا النيجاتيف، وزوايا الصور الخضراء ذات المساحات العريضة أو ذات المساحات الفارغة.
انتونيوني يعود ليؤكد كرهه للحرفية، السينما بالنسبة له ليست حرفة، هناك شيء ما يُظهر ندم انتونيوني او حسرته على الطريقة التي تتطور فيها الفنون، أو تتطور من خلالها المجتمعات، هناك شوارع خلفية تحوي اسرى حرب، وعمال مناجم، اضطر ذلك المصور للتخفي كي يجدها ويعيشها، اضطر لدفع رشوة لاحد الحراس كي يدخل لها، ولكنه خارج هذا المكان، يستقل سيارته الفارهة، والتي يجوب بها ارجاء لندن الساحرة بمبانيها الحمراء والزرقاء، بكل ذلك الاختلاف عن هذا المكان البائس المخفي في مجاهل لندن.
صنع انتونيوني تلك النوعية من الافلام التي يحللها النقاد مشهدا بمشهد، كالمواطن كين وراشمون وأوردت.. ألوان الأبنية، طريقة تثبيت الكاميرا على حافة السيارة السوداء، التي أظهرت ذلك الجانب المتلألأ من ابنية لندن.
كما قدم الفيلم واحدة من افضل الكوادر التي اخذها انتونيوني، افضل زوايا تصوير واكثرها دقة وفن، واشدها تعبيرا وتفاصيلا، دقة في اختيار ألوان المشهد، واختيار حركة الكاميرا ، ورصد تعابير الشخصيات، ويعتبر الفيلم عن جدارة درس سينمائي على الصعيد التقني، ومن خلفها المقصد، هناك شيء ما في تلك المدينة، اشبه ما يكون بمنديل حرير يغطي الشوك، هناك في لندن – تلك المدينة الكونية – تسير الامور باتجاه غير عادل، فنرى ذلك المصور المحترف، يدخل الاستديو الخاص به، ويتقابل بتلك الحسناء – الموديل – التي انتظرته لساعات كي يأخذ لها بضعة صور، هذا المصور المحترف الذي يمثل ذلك الاتجاه الذي تنحرف إليه تطور المدينة وتجسيد افكارها المعاصرة، التي تــُظهر ما لا تكمن، تــُظهر ما لا تحوي، هناك جمال غير عادي، جمال في مظهر المدينة اثناء قيادة المصور المحترف لسيارته الغالية الثمن، وفي مظهر تلك الفتيات اللواتي يتوسلن العمل كموديل، وتلك الحسناء التي انتظرت المصور لساعات كي يأخذ لها بعض الصور، هذا الجمال المزيف، جمال للبيع، للعرض لا أكثر، فتلك الابنية الحمراء، تغطي وراءها ازقة مكتظة بعمال مناجم واسرى حرب، وتلك الحسناوات، لا يملكن أكثر من جمالهن لابرازه، هذا المصور ليس إلا تاجر جمال، تاجر سلعة، محترف، وهذا ما يمقته انتونيوني.
وتبدأ جلسة التصوير، ليبدأ انتونيوني في صياغة فكرته عن الاحتراف في هذه المهنة التي تُبرز مدى التناقض التي تعيشه هذه المدينة، ويأخذنا انتونيوني في هذا المشهد لابعد ما يمكن تصوره، وهو ان يُظهر جلسة التصور اشبه ما تكون بعملية ممارسة جنسية، بدت فيها العارضة اشبه بدمية أو بعجينة، بين يدي هذا المصور الذي يُحرضها لاظهار ابرز مافي مفاتنها من جمال، كي يتمكن من تجميده على ورق، في صورته لهذه الموديل، ولكن في الليل في مشهد آخر سنرى تلك الموديل بتلك الحقيقة التي تحاول لندن بكل ألوانها أن تخفيه، – حياة الليل – التي تمكنت لندن من بيعه، من استغلال مافيه من جمال، لبيعه لذلك المصور الذي لا يتوانى عن توجيه كافة اشكال الاهانة لعارضاته كي يتمكن من التقاط صور لهن، وهذا ما اعطاه مطلق الصلاحية لأن يفعل بهن ما يرغب، يطردهن، يصرخ في وجوههم، يمارس معهن العاب التعري، فلندن الجديدة، لندن الملونة، تحتاج لتضحيات جديدة، شيء اشبه ما يكون بشرعنة الدعارة – بتلوينها – ولهذا السبب قدم انتونيوني تلك الفتاتان الراغبتان في العمل كموديل بهذه الطريقة رغم قيام توماس بطردهما بشكل مهين ولكنهما بقيتا ملتصقتين به مستجديتان العمل، هذا ما جعل توماس يستلقي بعد جلسة التصوير الصباحية متعبا وكأنه وصل للنشوة مع تلك الموديل، هذه هي لندن الجديدة، وهؤلاء هم وجوهها اليوم، تلك هي طموحات شاباتها، تلك هي المهن التي تمنح الشاب القدرة على ممارسة الدعارة بشرعية تامة ولكن بتسميات اخرى وبسلع اخرى، وهذا ما جعل تحفة اثرية كتلك التي اشتراها من أحد محال التحف والإغراض التي تحمل قيمة تاريخية، تتحول من شيء ذو قيمة أثرية هامة إلى مجرد ديكور في الصور التي تـُبرز الجمال، هذا ما اراد انتونيوني ان يوضحه من كل ما نراه في هذا الفيلم، وهو التغير الذي يطرأ على قيمة الأشياء، ومع هذا التغير الحاصل تأتي القيمة التي يمثلها ذلك المصور المحترف بالمقارنة مع عمال المناجم، القيمة التي كانت عليها تلك المروحة الخشبية في مخزن التحف وكيف صارت في استديو التصوير، ولتلك المروحة حكاية اخرى.
انتونيوني يروي الكثير من وجهات نظره دون ان ندري، أو دون ان يكون لها – نظريا – تلك القيمة في الفيلم، ولكنها تبدو مع النظر للفيلم كقطعة واحدة أو ككيان واحد، تبدو وكأنها فرع يرفد النهر الأساسي، المصور مثلا يدخل لمحل التحف مرتين، مرة قبل ان يذهب للحديقة للتصوير، ومرة حينما عاد منها، في المرة الأولى وجدنا عجوزا جلفا قاسي الملامح والطباع، لم يكترث بزبونه وبدا أنه لا يملك الرغبة لبيعه من الأساس، بدا عليه الغضب وبدت عليه رغبات التخلص من زبونه، ولكن في المرة الثانية التي اتى بها استقبلته امرأة شابة بدت وكأنها تريد بيع أي شيء وبأي ثمن، وهذا ما حدث، هناك جيل قديم وآخر جديد، مر عليهما هذا الزبون، وهناك نوعية معاملة مختلفة حصل عليها المصور جراء عملية المساومة على شراء القطعة التي أرادها، وهذا ما يؤكد وجهة نظر انتونيوني فيما يسمى بعرفه – قيمة الأشياء وطريقة تقديرها –
وهذا ما سيتكرس في اواخر الجزء الأول من الفيلمفي مشهد المنعطف أو المفصل، المشهد الذي يدخل فيه هذا المصور إلى أحد المقاهي ويُبرز ألبوم صوره لأحد معارفه ويقول له، ما رأيك، يجاوبه أنها رائعة، نلقي بنظرة على تلك الصور فإذا بها صور عمال المنجم، بكل ما تحمله من بؤس وخراب وضياع وتشرد، ولكنه يقول في ختام حواره، جملة تحمل الفيلم على عاتقها وهي – هذه الصور ستكون لألبومي، ولكني سأختمها بصورة هادئة وثابتة، اريد نهاية الالبوم أن تكون هادئة، بينما بقية الصور فأريدها عنيفة -، ولكن عن أي صورة هادئة يتحدث، أنها لتلك الصورة التي التقطها في أحدى المنتزهات المسالمة، الهادئة الخضراء الواسعة التي تحمل من الجمال الكثير (لدرجة تشك انها تخفي من وراء هذا الجمال شيئا).
يعود المصور للأستديو الخاص به فتتبعه صاحبة الصور وبدا الحاحها على استعادة فيلم التصوير غير البريء، وهذا ما أثار فضول المصور فسايرها ليصل لنقطة التقاء، وفي مشهد يعتبر واحدا من اجمل مشاهد الفيلم نرى فيه كم هي عظيمة هوامش الحرية التي صنعها هذا المجتمع لجزء من سكانه، ربما للوسماء فقط، أو للأغنياء فقط، المصور في هذا المشهد نتعرف على جزء كبير من شخصيته، هذا الرجل الذي يعيش حالة طيران، وانعدام وزن، يعيشها من خلال مهنته التي بدا مخلصا لها بجد وموهوبا بها فعلا، فاستملكته تلك المهنة التي يصر انتونيوني على وضعها تحت المجهر طيلة احداث الفيلم، وبدت وكأنها سيطرت على هذا الشاب فبدا اسيرها، وهذه فكرة اخرى احسن انتونيوني تقديمها، فأي نوع من التغييرات قد حصلت ؟، أهي تلك النوعية التي تجعل الحمقى يدورون الشوارع مطالبين بتوقف الحرب وسفك الدماء، ولكن هل من يقوم بذلك حمقى؟، أم هي تلك النوعية التي تجعل الشابات على استعداد لفعل أي شيء في سبيل العمل كعارضة ازياء، أو هي تلك النوعية التي تجعل الدخول لاحد المناجم يحتاج لدفع رشوة لرصد طبيعة العمل هناك، أو هي تلك النوعية التي تجعل أهدأ الصور وأكثرها سلاما وأكثرها تعبيرا عن وجه لندن الجديد، مسرحا لجريمة قتل غامضة.
هنا انتونيوني يصل للقمة، حيث يقول لمشاهديه شاهدوا كم أنا عظيم، وجارح وقاسي، شاهدوا كيف عريت لكم مجتمعكم ، شاهدوا ذلك المصور كيف يبحث في أكثر الزوايا ظلمة في أكثر الصور هدوءا وسلاما عن الجريمة، شاهدوا كيف اكتشفها، وكأنه اكتشف اللغز، شاهدوا كيف ان ذلك الالبوم الممتليء بالبؤس والقهر والذل والعنف انتهى بصورة هادئة، تحمل في خفاياها جريمة قتل، تحمل في زواياها سلاما خادع وهدوءا كاذب، شاهدوا كيف تحول مجتمعكم.
ومع هذا الوجه الجديد، لوجه لندن الجديد، سنعرف لماذا يسيطر الوهم على المظهر، والواقع تحت ذلك المنديل الحريري، وجمال العارضات الأخاذ والأبينة الملونة الرائعة الجمال، ليست سوى عنف عمال مناجم قبيحين، وفي هذه المفارقة التي جعلت المصور يبحث عن جريمة غامضة ومختبئة في الصورة الاكثر سلاما وهدوءا، وينسى الجرائم المعلنة في صور العنف في مقدمة ألبومه، يتناساها، بل لا ينظر لها على أنها جرائم، لا يراها سوى من ناحية جمالية بحتة، لا يرى ما فيها من وجه قبيح لذات المدينة التي ظهرت في صورة الجريمة هادئة مسالمة وخضراء، مع عاشقين يتبادلان الحب، وهكذا ظهر العنف في صور عمال المنجم انعكاسا في الصورة الهادئة المسالمة للوجه الآخر، طرف خيط غير مقطوع، واجهة انزاحت عن حيزها الوهمي، وهنا نرى كيف انتونيوني يلعب بالوهم، ونرى المصور في حالة الصدمة والخيبة، ليس في تلك الصورة الختامية السلام الذي ينشده، وليس فيها ذلك الهدوء بل فيها من البشاعة ما لا يحتمله عقل، وفيها من الكآبة والعنف ما يزيد عن صور عمال المنجم لأنها غير ظاهرة وواضحة، تجري كالظلال من تحت هدوء المدينة وابنتيها الحمراء والسيارات السوداء والاستديو الفاره الكبير الذي اصبح ملجأ للجميلات، هذا هو الوهم الذي تحدث عنه كيسلوفيسكي الذي لا يجب ان يُعامل بموضوعية،والذي يكون أكثر قوة من الواقع، وأكثر قدرة على كشف الحقائق حتى من الحقائق ذات نفسها في الصور البيضاء والسوداء، ومن الوجوه القبيحة العارية المشردة ، ومن عمال المناجم ذات نفسهم وهم الجريمة أقوى من الجريمة.
ما يثبت قوة انتونيوني في الاخراج، وما يعنيه انتونيوني كمخرج ، يظهر في المشهد الاخير من رائعته تلك، فمع توالي احداث الفيلم ، ظل الوهم حبيس مخيلة المشاهدين ومخيلة انتونيوني حتى اراد الختام، المشهد الختامي يتجسد الوهم بطلا ليظهر في كم من الوهم يعيش البشر، حيث يُظهر أن التغيير في كثير من الاحيان ليس سوى وهم، لكن الواقع مازال مختبئا حتى لو امتنعنا عن مشاهدته، حتى لو ظل حبيس الظلمة وراء الجدران، ولو أغلقنا اعيننا عنه، فليس كل التغيير تغييرا، فالوهم يمنح شعور التغيير ويعطي لمصور محترف قيمة قد لا يستحقها، كما يعطي لعارضة الازياء حياة غير سوية، ولكن بالمطلق هذا التغيير منحها الشرعية، كما ينزع عن تلك القطعة الأثرية قيمتها التاريخية ويستغل قيمتها الجمالية ويمنحها لفستان ترتديه عارضة أو موديل.
هؤلاء الحمقى أو المجانين بالطريقة التي صورهم فيها انتونيوني، هم انعكاس للحقيقة الوحيدة في عالم وهمي، استقل الحمقى سيارتهم وارتادوا ملعب التنس، وأخذوا يلعبون دون كرة ودون مضرب ويتقاذفون الكرة ويتبعونها بعينيهم، وتنتقل الكاميرا لعيني المصور فنراه يتبع الكرة الوهمية، يتبع الوهم ولا يراه ، كما ألوان الابنية واجساد العارضات، الحمقى يتقاذفون الهواء، فتعلو كرة الوهم عاليا خارج الملعب، المصور يسايرهم في جنونهم ويتبع الكرة يحملها ويرميها، وتبقى الكاميرا عالقة على وجهه وصوت خافت يظهر يعلو ويعلو يعلو أكثر، أنه صوت الكرة ، فالوهم يصدر صوتا حقيقيا، الوهم ليس وهما، أنه حقيقة والكرة حقيقية، صوت صادم ومخيف لكل من انسجم مع فكرة انتونيوني وفيلمه .. صوت قادر على منح المشاهد شعور القشعريرة، صوت قادر بالطريقة التي قدمها انتونيوني بعد ساعتين من المعالجة المتقنة على اسالة العرق البارد.
كم أنت عبقري يا انتونيوني، صنعت فلما بطله الوهم، وصنعت فيلما بدا وكأنه اثارة، واردت لجميع المشاهدين ان يتفاعلو مع الجريمة الغامضة لتصفعهم في ختام الفيلم بحقيقة الوهم.
سعفة اخرى وترشيح آخر لأوسكار افضل مخرج، وقوة الوهم كافية لتضعك في مصاف ما انجب التاريخ من مخرجين تركوا بصمه مختلفة ومتميزة.